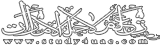-
عضو جديد

.jpg)
 طلب اريد بحـــث عــن ابــــن خلــــدون
طلب اريد بحـــث عــن ابــــن خلــــدون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيفكم أعظاء المنتدى الكرام؟؟
بس عندي طلب وياريت تساعدوني
ابغي بحث عن ابن خلدون
مب لازم مقدمه وخاتمه انا بسويهم بس ابغي الموضووع
وهذي الفصول اللي ابغيها في الموضوع
الفصل الاول: حياة ابن خلدون
الفصل الثاني: كتبه ومؤلفاته
الفصل الثالث: منهجية البحث عند ابن خلدون
وبس
اتمنى انكم تلبون طلبي
-
عضو جديد

.jpg)
 هاللي قدرت احصله
هاللي قدرت احصله
لمقــدمة2)
الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلا على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين..وبعد.. سأتحدث في موضوعي عن شخصية بارزه وهو ابن خلدون.
في البداية أود أن أعلم قراء تقريري هذا بسبب اختياري لموضوعي الذي يتناول الحديث عن عالم من العلماء, فقد اخترت هذا العالم المشهور فهو أشهر من نار على علم, لما أنـــــجزه في العالم والتاريخ فهو خير رمز وقدوة لـــــــــكل عربي يود أن يحدث نقلة في حياته لا بل في مجتمعه لا لا بل كل من لديه طموح و فكر لا يتوقف حد معين فيحدث نقلة في التاريخ ,إنه عظيم , جليل, بالتأكيد تتساءلون من هو ياترى, إنه ومن هم من أمثاله في نظري هم الثروة الحقيقة التي نحتاجها لهذا المجتمع, أعلمتم من هو الآن؟ إنه العلامة عبدالرحمن ابن خلدون, إذا فلنتعرف عليه. وسبب اختياري هذا الموضوع هو دراستي لـه ومعرفـة مزيد من المعلومات عن شخصيته وحبي لشخصيته, وقد اردت في هذا التقرير المتواضع ان اجمع قدر الامكان من المعلومات واسأل الله أن يوفقني في هذا التقرير وحسبي انني لن ادخر جهدا* في محاولة الوصول به الى درجة الاتقان*,لكن الكمال لله وحده ونسأل الله التوفيق والسداد.
الموضوع3)
اسمه: ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خالد (خلدون) الحضرمي..مؤسس علم الاجتماع ومؤرخ مسلم من إفريقية في عهد الحفصيين وهي تونس حالياً ترك تراثاً مازال تأثيره ممتداً حتى اليوم. ولد ابن خلدون في تونس عام 1332م (732هـ) بالدار الكائنة بنهج تربة الباي رقم 34. أسرة ابن خلدون أسرة علم وأدب، فقد حفظ القرآن الكريم في طفولته ، وكان أبوه هو معلمه الأول, شغل أجداده في الأندلس وتونس مناصب سياسية ودينية مهمة وكانوا أهل جاه ونفوذ، نزح أهله من الأندلس في منتصف القرن السابع الهجري، وتوجهوا إلى تونس ، وكان قدوم عائلته الى تونس خلال حكم دوله الحفصيين..
1)حيــاتـــهـ :
قضى أغلب مراحل حياته في تونس والمغرب الأقصى وكتب الجزء الأول من المقدمة بقلعة أولاد سلامة بالجزائر، وعمل بالتدريس، في جامع الزيتونة بتونس وفي المغرب بجامعة القرويين في فاس الذي أسسته الأختان الفهري القيروانيتان وبعدها في الجامع الأزهر بالقاهرة، مصر والمدرسة الظاهرية وغيرهم [2]. وفي آخر حياته تولى القضاء المالكي بمصر بوصفه فقيهاً متميزاً خاصة أنه سليل المدرسة الزيتونية العريقة و كان في طفولته قد درس بمسجد القبة الموجود قرب منزله سالف الذكر المسمى "سيد القبّة". توفي في القاهرة سنة 1406 م (808هـ). ومن بين أساتذته الفقيه الزيتوني الإمام ابن عرفة حيث درس بجامع الزيتونة المعمور ومنارة العلوم بالعالم الإسلامي آنذاك...
هو مؤسس علم الاجتماع وأول من وضعه على أسسه الحديثة، وقد توصل إلى نظريات باهرة في هذا العلم حول قوانين العمران ونظرية العصبية، وبناء الدولة و أطوار عمارها وسقوطها. وقد سبقت آراؤه ونظرياته ما توصل إليه لاحقاً بعدة قرون عدد من مشاهير العلماء كالعالم الفرنسي أوجست كونت..
2) نظرياته وانجازاته :
1)علم التاريخ :
و هكذا فهو وان لم يكتشف مادة التاريخ فانه جعلها علما ووضع لها فلسفة ومنهجا علميا نقديا نقلاها من عالم الوصف السطحي والسرد غير المعلل إلى عالم التحليل العقلاني و الأحداث المعللة بأسباب عامة منطقية ضمن ما يطلق عليه الآن بالحتمية التاريخية، و ذلك ليس ضمن مجتمعه فحسب، بل في كافة المجتمعات الإنسانية وفي كل العصور، وهذا ما جعل منه أيضا وبحق أول من اقتحم ميدان ما يسمى بتاريخ الحضارات أو التاريخ المقارن.و عندئذ أفهم تاريخ الجنس البشري في إطار شامل ...اني ابحث عن الاسباب و الأصول للحوادث السياسية. كذلك قوله"داخلا من باب الاسباب على العموم على الاخبار الخصوص فاستوعب أخبار الخليقة استيعابا" و أعطي الحوادث علة أسبابا ..
2) علم الاجتماع :
ان النتيجة التي توصل اليها ابن خلدون في الفصل الثاني من مقدمته عند بحثه للعمران البدوي و هي(ان اختلاف الأجيال في أحوالهم انما هو باختلاف نحلهم من المعاش)) قادته بالضرورة إلى دراسة عدة مقولات اقتصادية تعتبر حجر الزاوية في علم الاقتصاد الحديث، مثل دراسة الأساليب الإنتاجية التي تعاقبت على المجتمعات البشرية، و انتقال هذه الأخيرة من البداوة إلى الحضارة، أي من الزراعة إلى الصناعة و التجارة(...و أما الفلاحة و الصناعة و التجارة فهي وجوه طبيعية للمعاش .أما الفلاحة فهي متقدمة عليها كلها بالذات..و أما الصناعة فهي ثانيها و متأخرة عنها لأنها مركبة و علمية تصرف فيها الأفكارو الأنظار ، و لهذا
لا توجد غالبا إلا في أهل الحضر الذي هو متأخر عن البدو و ثان عنه))
3) فلســـفـه ابن خــلـدون :
امتاز ابن خلدون بسعة اطلاعه على ما كتبه القدامى على أحوال البشر وقدرته على استعراض الآراء ونقدها، ودقة الملاحظة مع حرية في التفكير وإنصاف أصحاب الآراء المخالفة لرأيه. وقد كان لخبرته في الحياة السياسية والإدارية وفي القضاء، إلى جانب أسفاره الكثيرة من موطنه الأصيل تونس و بقية بلاد شمال أفريقيا إلى بلدان أخرى مثل مصر والحجاز والشام، أثر بالغ في موضوعية وعلمية كتاباته عن التاريخ وملاحظاته.
4) الغرب وابن خلدون :
كثير من الكتاب الغربيين وصفوا تقديم ابن خلدون للتاريخ بأنه أول تقديم لا ديني للتأريخ ، وهو له تقدير كبير عندهم. ربما تكون ترجمة حياة ابن خلدون من أكثر ترجمات شخصيات التاريخ الإسلامي توثيقا بسبب المؤلف الذي وضعه ابن خلدون ليؤرخ لحياته و تجاربه و دعاه التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا و غربا ، تحدث ابن خلدون في هذا الكتاب عن الكثير من تفاصيل حياته المهنية في مجال السياسة والتأليف والرحلات، ولكنه لم يضمنها كثيرا تفاصيل حياته الشخصية والعائلية.
5) وظايف تولاها :
كان ابن خلدون دبلوماسياً حكيماً أيضاً . وقد أُرسل في أكثر من وظيفة دبلوماسية لحل النزاعات بين زعماء الدول: مثلاً، عينه السلطان محمد بن الاحمر سفيراً له إلى أمير قشتالة للتوصل لعقد صلح بينهما و كان صديقاً مقرباً لوزيره لسان الدين ابن الخطيب .كان وزيراً لدى أبي عبد الله الحفصي سلطان بجاية ، وكان مقرباً من السلطان أبي عنان المريني قبل أن يسعى بينهما الوشاة . وبعد ذلك بأعوام استعان به أهل دمشق لطلب الأمان من الحاكم المغولي القاسي تيمورلنك.
6) كتــبه ومؤلفـاتـه :
تاريخ ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في معرفة أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر..
شفاء السائل لتهذيب المسائل: نشره وعلق عليه أغناطيوس عبده اليسوعي..
التعريف بابن خلدون:رحلاته شرقا وغربا (مذكراته)..
7) وفـــاتــهـ :
توفي في مصر عام 1406 م، و دفن في مقابر الصوفية عند باب النصر شمال القاهرة. وقبره غير معروف. والدار التي ولد بها كائنة بنهج تربة الباي عدد 34 بتونس العاصمة بالمدينة العتيقة.
الخاتمة:-(4)
الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وهادياً للناس أجمعين صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد: واخيرا وليس اخرا فاتمنى ان تكون هذه الشخصية نموذجا بارزا لكل تائه وباحث عن طريق الهداية والنور وهي (ابن خلدون) .
بعد الانتهاء من هذه الرحلة التي عرضنا فيها"عن شخصية بارزه وهو روجيه جارودي" ومن المعلومات التي يتناولها هذا التقرير وهي كثيرة.
وفي الختام أشكر كل من ساهمني في هذا التقرير وعلى رأسهم الاستاذ الفاضل مدرس التاريخ وأرجو ان يكون هذا التقرير قد نال اعجابكم وافادكم.
وآخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمين.,الله ولي التوفيق والسموحه على القصور, لكن الكمال للـه وحده ونسأل الله التوفيق.والسداد. والسداد.
المصادر والمراجع:- (5)
(1)الموسوعة العربية العالمية
(2)كتاب الطالب المدرسي للصف الحادي عشر(أدبي) صفحة 30-31-32-33
(3) ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
(4) *د.حميدة عبدالرحمن, رئيس قسم الجغرافيا, أعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم, دار الفكر.
(5) ابن خلدون الشخصية التاريخية
اتمنى التوفيق للجميع
-
عضو جديد

.jpg)

مشكور أخوي
الله يوفجك فحياتك
-
عضو جديد

.gif)

لو سمممحتوا ابغي خطة بحث ضرووووري
-
عضو جديد



الفهرس
1-المقدمة........................................... ................... 2
الفصل الأول
2- حياته............................................. ................... 3
3- فلسفة ابن خلدون............................................. ....... 7
الفصل الثاني
4- الفكر الإجتماعى لدى ابن خلدون..................................... 8
5-المنهج التعليمي عند ابن خلدون....................................... 11
6-رحلة الخلود " وفاته............................................. ...... 12
5-الخاتمة........................................... .................... 13
6-المراجع........................................... ................... 14
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين عليه وعلى آله وصحبه الطيبين والتابعين أجمعين.
وبعد
فهذا البحث الذي بين أيديكم وهو يتحدث عن عالم جليل من علماء العرب وهو أبن خلدون وفيه سأتناول جزء عن حياته ومؤلفاته وإسهاماته وسوف أحاول من خلال هذا البحث المتواضع من تقديم شرح الموضوع وأرجو أن يحوز هذا العمل المتواضع رضاكم وأن ينتفع به كل من يطلع عليه ولقد تناولت هذا الموضوع بالدراسة ولست أول من يقوم بهذا ي محاولة مني لاستكشاف جميع الجوانب المتعلقة بهذا العالم الجليل ولدورة الكبير في علم الاجتماع .
ابن خلدون
حياته:
ابن خلدون (الاسم الكامل : ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خالد (خلدون) الحضرميولد في تونس غرة رمضان سنة 732 هـ مايس سنة 1332 م في دار مازالت عامرة حتي يومنا، " تقع في شارع (تربة الباي) من تونس المدينة القديمة، وفيها شب وتعلم، حيث كان ابوه معلمه الاول. وهو مؤسس علم الاجتماع ومؤرخ شمال أفريقي مسلم ترك تراثا مازال تأثيره ممتدا حتى اليوم . ، فقد حفظ القرآن الكريم في طفولته ، وكان أباه هو معلمه الأول [1], شغل أجداده في الأندلس وتونس مناصب سياسية ودينية مهمة وكانوا أهل جاه ونفوذ، نزح أهله من الأندلس في أوساط القرن السابع الهجري, وتوجهوا إلى تونس حاضرة العلوم آنذاك وكان قدوم عائلته إلى تونس خلال حكم دولة الحفصيين . ينتهى نسبه بالصحابى وائل ابن حجر الحضرمى الذى كان النبى صلى الله عليه وسلم قد دعا له :
"اللهم بارك في وائل ابن حجر وبارك في ولده وولد ولده إلى يوم القيامة ثم اختلف علي العديد من العلماء والمشايخ الذين استقطبتهم تونس من مختلف بلاد المغرب والاندلس بعد ان ساءت احوالهم في تلك البلاد فحفظ عليهم القرآن وجوده بالقراءات السبع- وكذلك بقراءة يعقوب إبن اسحق البصري. وتقف عنهم علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه واصول وتوحيد، ودرس علوم اللسان من لغة ونحو وصرف وبلاغة وادب وتاريخ ثم درس المنطق والفلسفة وعلوم الطبيعة والرياضة.
ولقد اظهر في كل اولئك نبوغا اعجب شيوخه ومعلميه ويذكر -ابن خلدون، اسماء من درس عليهم واخذ عنهم في كتابه (التعريف بابن خلدون) الذي يختتم به كتاب العبر في التاريخ ويترجم بعناية وتفصيل لنفسه ولاثنين من شيوخه. هما محمد بن عبد المهيمن الحضرمي، امام المحدثين والنحاة في المغرب، الذي اخذ عنه الحديث والسيرة وعلوم اللغة وابو عبد الله محمد بن ابراهيم الابلي الذي اخذ عـنـه الفلسفة والمنطق والطبيعة.
ومن الكتب التي اثر ابن خلدون ان يقف عندها في تعريفه اللامية في القراءات والرائية في رسم المصحف للشاطبي وكتاب التسهيل في النحو لابن مالك والاغاني لابي الفرج الأصبهاني والمعلقات وكتاب الحماسة للاعلم الشنتمري وديوان ابي تمام وديوان المتنبي والصحاح الست خاصة صحيح مسلم وموطا مالك وكتاب التهذيب للبرادعي ومختصر ابن الحاجب في الفقه والاصول ومختصر سحنون فــي الفقه المالك لابن اسحـق.ولما بلغ ابن خلدون الثامنة عشرة اجتاح تونس الطاعون فاهلك فيمن اهلك ابويه وجميع من كان ياخذ عنهم العلم، فاستوحش لذلك ورغب في ان يهاجر الي المغرب الاقصي مع من هاجر من العلماء والشيوخ في صحبة السلطان ابي الحسن صاحب دولة بني مرين، الا ان اخاه الاكبر صرفه عن ذلك.فاقام في تونس ولكن ليعزف عن الدرس الذي لم يبق في تونس من الشيوخ والعلماء من يرغبه فيه بعد هجرة عامتهم مع ابي الحسن، وقرر ان يجرب حظه في الحياة العملية فتطلع الي اعمال الدولة ورغب في مناصبها، متابعا في ذلك سيرة اجداده في توليه امور الدولة والقيام علي خدمة اغراض السلطان.
وفي اثر خروج السلطان ابي الحسن الي المغرب، زحف الفضل بن السلطان ابي يحيي الحفصي علي تونس لينتزعها من يد بني مرين بعد ان كانوا قد استولوا عليها وقتلوا اباه سنة 748 هـ ولكن لم يلبث الفضل طويلا حتي عزله وزيره ابو محمد بن تافراكـين ليولي مكانه اخاه الاصغر ابا اسحق بن ابي يحيي، وليستبد هو بالملك من دونه.
وفي عهد الوزير هذا تولي ابن خلدون سنة 751 هـ كتابه العلامة للسلطان، وكانت هذه اول وظيفة يتولاها في دولة بني حفص.
ويبدو انها كانت في حاجة الي نبوغ ابن خلدون في الانشاء والصياغة لتستقيم ديباجته مع موضوع الامر او المرسوم اللذين يصدران باسم السلطان ولكن لم يكد ابن خلدن ان يستقر في هذه الوظيفة حتي زحف ابو زيد حفيد السلطان ابي يحيي الحفصي، امير قسنطينة علي تونس لينتزعها من يد الوزير الغاصب ابن تافراكين ويعيدها خالصة لبني حفص، ويهرب ابن خلدون الي الجزائر ويستقر في بسكرة ويتزوج هناك نحو عام 754 هـ ولما ولي ابو عنان بن ابي الحسن ملك المغرب الاقصي بعد وفاة ابيه، عمل علي استعادة ما استولي عليه ابوه من يد بني حفص في المغرب الادني وتونس وبني عبد الواد في المغرب الاوسط ولما تم ذلك واستقر في تلمسان- قاعدة المغرب الاوسط، سعي له ابن خلدون وجهد في التقرب منه فالحقه هذا ببطانته وعينه عضوا في مجلسه العلمي بفاس وكلفه شهود الصلوات معه سنة 755 هـ ثم رفعه ليكون ضمن كتابه وموقعيه.
وفي فاس عاود ابن خلدون الدرس والاتصال بالشيوخ والعلماء من المغرب وممن وفد عليها من الاندلس، وبلغ من ذلك البغية علي انه ذكر في كتاب (التعريف) وفي الوقت نفسه يتطلع الي المزيد من الحظوة لدي السلطان والرقي في مناصب الدولة.
وقد قاده ذلك التطلع والاشرأباب المحمومين الي الاشتراك في مؤامرة ضد السلطان مع الامير ابي عبد الله محمد الحفصي الذي خلعه السلطان عن بجاية واحتفظ به اسيرا في فاس ولما بلغ ابا عنان خبرهما قبض علي ابن خلدون والامير المخلوع وسجنهما ولم يسمع لهما تضرعا او شفاعة فظلا في السجن ثم اطلق سراح الامير محمد وبقي ابن خلدون في السجن حتي سنة 759 هـ حيث كتب الي ابي عنان قصيدة طويلة رق لها الامير. ووعد بالافراج عنه وكان يومها في تلمسان ولكن الموت عاجل الاسير فتوفي قبل ان يغادر الي فاس ويفي بوعده في إطلاق سراحه وقال في هذا قصيدة وهي طويلة في نحو مئتي بيت. ذكر معظمها في كتاب التعريف ثم ان الوزير الحسن بن عمر عزل السلطان الجديد ابا زيان بن ابي عنان واقام علي العرش طفلا هو اخوه سعيد بن ابي عنان ليستبد بالملك دونه، وبادر بعد ان صفي منافسيه من وزراء وامراء الي اطلاق سراح المعتقلين ومن جملتهم ابن خلدون. ورده الي سابق وظائفه واحسن اليه. ورفض طلبه باعتزال العمل والانصراف الي الدرس في تونس.
ولكن ما ان وثب منصور بن سليمان من بني مرين بالمغرب الاقصي وانتزع الامر من الوزير، حتي انقلب ابن خلدون علي الوزير واتصل بالسطان الجديد فقربه هذا واعلي مكانه، ولكنه لم يلبث ان غادره الي طالب عرش جديد هو ابو سالم بن ابي الحسن- احد اخوة ابي عنان الذي استطاع بتدبير محكم من ابن خلدون ان يقصي منصور بن سليمان ليتربع هو علي عرش ابيه وليجعل ابن خلدون في كتاب سره والانشاء في مخاطباته والترسل عنه وقربه واحسن اليه.
ولقد نهض ابن خلدون بمهمته هذه علي احس وجه. فطور اساليب الانشاء والمخاطبات محررا اياها من التصنع والاسجاع المتكلفة. وبالغا بما شأواً لم يدنه فيه احد. يذكر هو ذلك في كتاب (التعريف) فيقول (كان اكثر الرسائل يصدر عني بالكلام المرسل، ولم انتحل الكتابة في الاسجاع لضعف انتحالها وخفاء العالي منها علي اكثر الناس بخلاف المرسل فانفردت به يؤمئذ. وكان مستغربا عندهم بين اهل الصناعة (يقصد كتاب الرسائل)، ثم اخذت نفسي بالشعر فانثال علي منه بحور توسطت بين الاجادة والقصور).
فلسفة ابن خلدون:
امتاز ابن خلدون بسعة اطلاعه على ما كتبه الأقدمون وعلى أحوال البشر وقدرته على استعراض الآراء ونقدها، ودقة الملاحظة مع حرية في التفكير وإنصاف أصحاب الآراء المخالفة لرأيه. وقد كان لخبرته في الحياة السياسية والإدارية وفي القضاء، إلى جانب أسفاره الكثيرة في شمالي إفريقيا وغربيها إلى مصر والحجاز والشام، أثر بالغ في موضوعية وعلمية كتاباته عن التاريخ وملاحظاته يرى ابن خلدون (ت 808هـ، 1406م) في المقدمة أن الفلسفة من العلوم التي استحدثت مع انتشار العمران، وأنها كثيرة في المدن ويعرِّفها قائلاً: ¸بأن قومًا من عقلاء النوع الإنساني زعموا أن الوجود كله، الحسي منه وما وراء الحسي، تُدرك أدواته وأحواله، بأسبابها وعللها، بالأنظار الفكرية والأقيسة العقلية وأن تصحيح العقائد الإيمانية من قِبَل النظر لا من جهة السمع فإنها بعض من مدارك العقل، وهؤلاء يسمون فلاسفة جمع فيلسوف، وهو باللسان اليوناني محب الحكمة. فبحثوا عن ذلك وشمروا له وحوَّموا على إصابة الغرض منه ووضعوا قانونًا يهتدي به العقل في نظره إلى التمييز بين الحق والباطل وسموه بالمنطق.• ويحذّر ابن خلدون الناظرين في هذا العلم من دراسته قبل الاطلاع على الشرعيات من التفسير والفقه، فيقول: ¸وليكن نظر من ينظر فيها بعد الامتلاء من الشرعيات والاطلاع على التفسير والفقه ولا يُكبَّنَّ أحدٌ عليها وهو خِلْو من علوم الملة فقلَّ أن يَسلَمَ لذلك من معاطبها•. ولعل ابن خلدون وابن رشد اتفقا على أن البحث في هذا العلم يستوجب الإلمام بعلوم الشرع حتى لا يضل العقل ويتوه في مجاهل الفكر المجرد لأن الشرع يرد العقل إلى البسيط لا إلى المعقد وإلى التجريب لا إلى التجريد. من هنا كانت نصيحة هؤلاء العلماء إلى دارسي الفلسفة أن يعرفوا الشرع والنقل قبل أن يُمعنوا في التجريد العقلي.
الفكر الإجتماعى لدى ابن خلدون:
يعتبر ابن خلدون العصبية هى الركيزة الأساسية لأى نشاط سياسى أو أجتماعي ، وأن الدولة لكى تقوم تحتاج إلى رابطة تجمع الأفراد تحت لوائها وتدفعهم للتضحية من أجلها ، والعصبية تقوم بهذا الدور ،إستنادا على الإنسان كائن إجتماعى الطبع ويحتاج إلى كيان ينتمى إليه يوفر الحاجات التى لا يستطيع توفيرها منفرداً ، إذن الفرد والقبيلة بإعتبارها أكثر أشكال الروابط شيوعاً وقتئذ كليهما بحاجة لأخر لتستقيم أمورهما معاً . ويرى ابن خلدون في المقدمة أن الفلسفة من العلوم التي أستحدثت مع إنتشار العمران، وأنها كثيرة في المدن ويعرِّفها قائلاً: ¸بأن قومًا من عقلاء النوع الإنساني زعموا أن الوجود كله، الحسي منه وما وراء الحسي، تُدرك أدواته وأحواله، بأسبابها وعللها، بالأنظار الفكرية والأقيسة العقلية وأن تصحيح العقائد الإيمانية من قِبَل النظر لا من جهة السمع فإنها بعض من مدارك العقل، وهؤلاء يسمون فلاسفة جمع فيلسوف، وهو باللسان اليوناني محب الحكمة. فبحثوا عن ذلك وشمروا له وحوَّموا على إصابة الغرض منه ووضعوا قانونًا يهتدي به العقل في نظره إلى التمييز بين الحق والباطل وسموه بالمنطق. ويحذّر ابن خلدون الناظرين في هذا العلم من دراسته قبل الإطلاع على العلوم الشرعية من التفسير والفقه، فيقول: ¸وليكن نظر من ينظر فيها بعد الامتلاء من الشرعيات والإطلاع على التفسير والفقه ولا يُكبَّنَّ أحدٌ عليها وهو خِلْو من علوم الملة فقلَّ أن يَسلَمَ لذلك من معاطبها•.
ولعل ابن خلدون وابن رشد إتفقا على أن البحث في هذا العلم يستوجب الإلمام بعلوم الشرع حتى لا يضل العقل ويتوه في مجاهل الفكر المجرد لأن الشرع يرد العقل إلى البسيط لا إلى المعقد وإلى التجريب لا إلى التجريد. ومن هنا كانت نصيحة هؤلاء العلماء إلى دارسي الفلسفة أن يعرفوا الشرع والنقل قبل أن يُمعنوا في التجريد العقلي.
بسبب فكر ابن خلدون الدبلوماسي الحكيم ، أُرسل أكثر من مرة لحل نزاعات دولية ، فقد عينه السلطان محمد بن الاحمر سفيراً إلى أمير قشتالة لعقد الصلح . وبعد ذلك بأعوام ، استعان أهل دمشق به لطلب الأمان من الحاكم المغولي تيمور لنك ، .وبعد أن زهد ابن خلدون العمل السياسي
قرر ابن خلدون أن يتناول مشروعا كان يداعبه منذ فترة طويلة و هو كتابة تاريخ العالم مع البدء بتاريخ المغرب الذي عاشه بشغف. و بجانب كونه مدنيا و تابعا لبلاط الأسر الحاكمة شارك ابن خلدون القبائل المغربية في الجنوب حياتهم اليومية.
لجأ ابن خلدون إلى خلوة دراسية بقلعة ابن سلامة (المعروفة اليوم باسم (فرندا) وهران بالجزائر) حيث تناول هذا العمل الذي أثراه بخبرته الشخصية و بثقافة علماء عصره التي تبناها و بمعرفته العميقة بالقرآن و تفسيره من خلال الفقه و السنة ، وزينه بأعمال الفلاسفة و رجال العلم و كذلك بأعمال المؤرخين العظماء الذي تمكن من قراءة كتاباتهم.
و سوف تسمح له تلك الخبرة و تلك الثقافة في خلوته من القيام بتلك المواجهة الضرورية بين النظرية و المشاهدة و هي الشرط الذي لا يقوم بدونه أي تفكير علمي,و كان ينوي ابن خلدون إعادة كتابة تاريخ المغرب و قد كان ؛ فبما أسماه بالمقدمة بدأ بالدفاع عن مشروعه من خلال نقد أعمال المؤرخين الذين سبقوه ؛ و في الواقع كان مشروع كتابة التاريخ يخفي مشروعا آخر و هو فهم و شرح السلطة في إطار مجتمعات المغرب و الكشف عن حقيقة دولة الأسر الحاكمة في المجتمعات المسلمة.
فأخذ على المؤرخين استخدامهم السيئ لمصادرهم مشككا في الإسناد (و هو اللجوء إلى سلسلة من الراوين للتصديق على الأفعال المروية) ، و غياب روح النقد لديهم و الميل إلى التحيز و أخذ عليهم خاصة اقتصارهم على رواية الأحداث دون محاولة شرحها من خلال وضعها في سياقها و محاولة فهم أشكال التغير ؛ فيقول ابن خلدون أن التاريخ "يهدف إلى دراسة المجتمعات الإنسانية" ؛ و يتوصل إلى أن من أجل تحليل المجتمع بشكل صحيح ينبغي خلق "علما جديدا" و هو العمران ، علم الحضارة الذي يصفه كعلم قائم بذاته "مستقل بنفسه" مقارنة بالفروع المعيارية الأخرى كالفلسفة و الخطابة (حديث عن المجتمع مخصص "لإقناع الجمهور ليقبل أو ليرفض وجهة نظر محددة" و السياسة المدنية. و كما فعل العلماء الاجتماعيون الأوروبيون في القرن التاسع عشر ، قام ابن خلدون بتعريف "العلم الجديد" من خلال موضوعه "العمران البشري" أو "الاجتماع الإنساني" و من خلال أساليبه.
المنهج التعليمي عند ابن خلدون :-
المتعلم هو الغرض، وطبيعته هي محور العلمية التربوية العلمية التربوية التعليمية :-
أولا : في الطرق التعليمية والتربوية : -
أ- التدرج والتكرار بما يناسب الطالب والموضوع معا : أن يتدرج مع الطالب بتلقينه مسائل من كل باب هي أصول ذلك الباب.
دون الدخول إلى التفاصيل، مراعيا قدرته وقابليته على فهم ما يلقى عليه. وفي المرحلة الثانية شرح جزيئات من الموضوع أكثر ارتباطا به، وبعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة حيث يدخل إلى الجزيئات والتفاصيل الأصغر دقة.
ب- عدم إرهاق فكر الطالب والاحاطة بطبيعة هذا الفكر : يقول أن الفكر الإنساني ينمو ويتطور تدريجيا، ويتأثر بما يكتسبه من معلومات ومهارات وما يعرض له من خبرات، هذه جميعها تتحكم كما وكيفيا في سلامة هذا النمو واتجاهه سلبا وإيجابا.
ت- عدم الانتقال من فن إلى آخر قبل فهمه : ولك خوفا من الخلط، وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم وأدركه الكلال وانطمس فكره، ويئس من التحصيل، وهر العلم والتعليم.
ث- النسيان آفة العلم، تعالج بالتتابع والتكرار : يريد ابن خلدون بمنهجه هذا ان يربي ملكات لدى الطالب. وتربية الملكة عند الإنسان تتطلب الاحتفاظ بما اكتسبه الطالب ليكون قادرا على استحضاره عند الحاجة.
ج- عدم الشدة على المتعلمين : لم يخف على ابن خلدون ما للشدة والقسوة على الطالب وخاصة على المبتدئ من نتائج سلبية.
رحلة الخلود " وفاته "
ظل ابن خلدون في الخمس سنوات الأخيرة من عمره في صراع وظيفي حول كرسي القضاء ، فقد أقيل من منصبه أكثر من مرة حتى عاد إلى القضاء للمرة السادسة والأخيرة وذلك في شعبان 808هـ، ومكث أياما قلائل انتقل بعدها فجأة إلى الرفيق الأعل،ى كان ذلك يوم الأربعاء لأربع بقين من رمضان، وكان عمره يقارب السادسة والسبعين عاما.
جاء هذا النبأ بعد حياة حافلة مثيرة لذلك المؤرخ المغربي الكبير، تقترب في وصفها من الشكل الملحمي شأن ما توصف به دائما حياة العباقرة من عظماء التاريخ.
خرج جثمان ابن خلدون من أحد البيوت القاهرية المطلة على النيل بعد أن تخلص من زيه المغربي الذي حرص على ارتدائه طوال حياته، وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير في موكب جنائزي مهيب يليق بوداع قاضي القضاة المالكية ، مخلفا وراءه سر خلوده ، وهو مؤلفه الضخم (كتاب العبر ، ديوان المبتدأ أو الخبر في أيام العرب والعجم والبربر ، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر(.
الخاتمة
فهذا البحث الذي بين أيديكم وهو كما ذكرنا في المقدمة يتحدث عن عالم جليل من علماء الامة الإسلامية وأرجو أن أكون قد وفقت في هذا العمل وأن كان تقصير فمن نفسي أن كان كمال فمن الله تعالى وارجوا أن ينفع الله بهذا العمل كل من يطلع عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
ومن النتائج التي يمكن أن نخرج بها من هذا البحث :
1- أن علمائنا قد سبقوا بتفكيرهم زمنهم .
2- يعد ابن خلدون هو المؤسس الحقيقي لعلم العمران البشر يوالمرسي الاساسي لقواعد علم الاجتماع الحديث .
3- سبق ابن خلدون بفكره عصرة وأرسي قواعد لم تكتشف إلا منذ فترة قصيرة .
التوصيات :
أوصي لكل من يطلع على هذا البحث أن يحاول جمع مواد علمية أخري وعرض الموضوع مرة ثانية نظراً لأهمية هذا البحث وللمكاسب التي ستعود على المطلع عليه .
المصادر والمراجع
1- ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون،ط5، (بيروت:1404هـ-1984م
2- علي الوردي، منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته، ( القاهرة: معهد الدراسات العربية العالمية، 1962م).
3- د.عبد السلام المسدي وآخرون مجلة الفكر العربي، ،الملف الأول ابن خلدون والمعرفة ، العدد :16، طرابلس- ليبيا، آب 1980م.
4- , د.محمد الطالبي مجلة دراسات تاريخيه ، منهجية ابن خلدون التاريخية وتأثيرها في المقدمة وكتاب العبر، العدد: الثالث، دمشق ، كانون أول 1980م
5- ابن خلدون،تاريخ ابن خلدون المسمى ” العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، اعتناء أبو صهيب الكرمي،(بيروت بيت الأفكار الدولية،د.ت)
6- عبد الله عنان،ابن خلدون” حياته وتراثه الفكري” ،(القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، 1925م).
7- طرلايف الخالدي ، فكرة التاريخ عند العرب من الكتاب إلى المقدمة , ترجمة حسني زينه , ط1, (بيروت ،دار النهار ،1997م).
-
عضو جديد


لو سمحتو اريد بحث مرتب عن ابن خلدون
الاسم :سماء الروح
 ضوابط المشاركة
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى